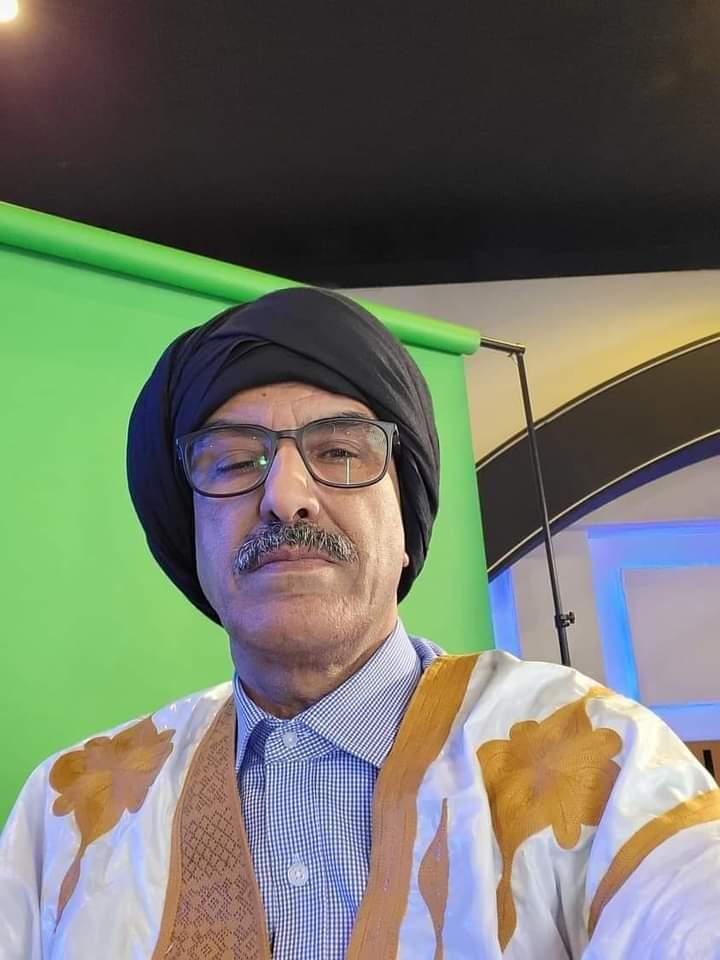الأمن الذوقي
كثيراً ما نتحدث عن الأمن العسكري، والأمن الغذائي، والأمن الاقتصادي، والأمن الصحي، والأمن القومي، والأمن الوطني، والأمن الدولي عموما، ولكننا قلما نفكر في الأمن الذوقي، أحرى أن نتحدث عنه، مع أن الذوق أصبح مهدداً بهيمنة ثقافة القبح، والعنف، والرداءة...
والأدهى والأمر أن الذوق عنصر هلامي مركب، من تفاعل الذات الفردية، والذات الجمعية، مع عوالمهما الخارجية، وهو يتشكل، ويتغير، وفق الثقافة السائدة، مما يجعل أمنه ربما أصعب من جميع مواضيع الأمن الأخرى، الآنفة الذكر.. لا سيما في ظل انفلات روافد الثقافة، وقنواتها من كل سلطات الرقابة والضبط التقليدية.
ومهما كانت سعة مفهوم الذوق، وتعدد مكوناته، وتشعب موضوعاته، فإن علاقتي الشخصية والتخصصية بالأدب العربي، تفرض عليّ إثارة هذا الموضوع المترامي الأطراف من هذه الزاوية بالذات، باعتبار خطورتها تكمن في علاقتها اللصيقة بالهوية.
فاليوم قد ماعت الهوية القومية بمفهومها الشامل، رغم تكاثر حَمَلة الشهادات العلمية العليا التي كانت مفقودة -عندنا- بألقابها، وإن توفر محتواها، ومعناها، وأصبح استقبال الروافد الثقافية فوضويا، لا يخضع لصمام حضاري شامل، يتَّحِد في الحفاظ على ثوابت الأمة... فانْتُهِكَتْ عندها كل الهويات... هوية الفكر والشعر وغيرهما... ولم نعد حقيقة نعرف ما الشعر... الذي نكتبه.. ونتعاطاه، وساعد على ذلك تضرر النقد الأدبي بهذه الآفات ذاتها، حيث لم تستطع الذائقة العربية – للأسف- على امتداد أكثر من نصف قرن - أن تبلور رؤية نقدية منبثقة من تربتها وبيئتها الطبيعة، وإنما ظلت تستورد المناهج النقدية، والموضات الأدبية، من الغرب، وبعد انتهاء صلاحيتها هناك، ودون مراعاة لاستحالة القياس مع وجود الفارق، مما جعلني - ذات مرة - أصف الممارسة النقدية عند العرب خلال هذه الفترة بـ«صندوق النقد الدولي» الذي يدمن كل العرب الاقتراض منه، حتى يظلوا دولا غنية، وشعوبا فقيرة، سواء على مستوى البنية التحتية «الاقتصاد»، أو البنية الفوقية «الثقافة».
وهكذا تاهت بوصلة الإبداع، وانتهكت معايير الجودة والتميز، وطردت العملة الرديئة العملة الجيدة من السوق، ومُكِّنَ لكل ناعق بصرعة مستوردة، تمييعا للمشهد، حتى لا تظل للأمة نواتها الصلبة الضامنة لهويتها المتميزة، وخَلَّى المبدعون الحقيقيون سطح الحياة للأدعياء، حتى أصبح المشهد الإبداعي – باختصار- مثل البحر، الذي يحتل الزبد سطحه، وترسب اللآلئ في قعره، ومثل جبل الثلج ما خفي من كتلته أعظم من مما يطفو، ومايزال ذلك ساري المفعول، فهناك دائما أدباء وشعراء ونقاد في الظل، في الهامش، أفضل ممن يحتلون دائرة الضوء، ويُمَكَّنُ لهم في واجهة الحياة.
والخلاصة: أن هذه الحركة الشعرية العربية لم تفرز - عبر نصف قرن- من عظماء الشعراء غير أسماء قليلة، لا تناسب امتدادها الزماني، ولا فضاءها المكاني، ولا تراثها الإنساني.
وقد أصبح الأدب مستثقل الظل في عهد طفرة الإعلام، وتعدد قنواته ووسائطه، حيث لم تعد الجهات الرسمية العربية تعطي أي عناية للأدب، وتمادت وسائلها الإعلامية في تقزيمه، وتهميشه، وتمييعه، وحتى الوسائل الإعلامية الدولية الناطقة بالعربية، والمستهدفة للإنسان العربي، تخلت عن معايير الجودة التنافسية، وساهمت في حملة التسطيح... فرحم الله زمانا كانت فيه إذاعة الـ«بي بي سي» وحتى وسائل إعلام العرب في أجيالها الأولى مدارس ثقافية، وأدبية تكوَّن عبْرها حتى الكثير من الأميين، عن طريق سماع برامجها الهادفة والمفيدة والممتعة، أما الآن فقد قتل الإعلام السائد الذوق الأدبي، حيث ندر بين رعاته وجود الأدباء، وسادت الثقافة الإعلامية الهابطة، رقصا ومجونا وعريا، وخلاعة، والثقافة الإعلامية المتوحشة، تقتيلا وتدميرا وتخريبا والثقافة الإعلامية الجشعة رهينة حركة الأسواق والبورصات، والدعاية والإشهار التجاري... ولم يبق للإعلام الأدبي هنا مكان من الإعراب، إلا بقدر ما يتماهى مع هذه الخطوط التحريرية الثلاثة المهيمنة على مشهدنا الإعلامي المادي البحت..
رحم الله شيخ العربية محمود شاكر، حين قال:«إلْفُ القبْح مُتْلِفٌ للإحْساس والعقل»!
الأمن الذوقي/الدي ولد آدب